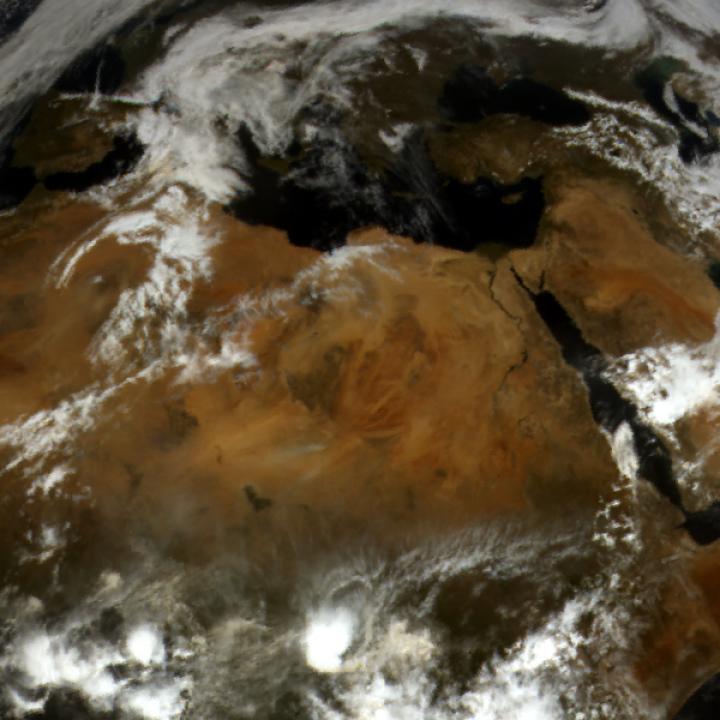
- تحليل السياسات
- منتدى فكرة
الاستقطاب والبحث الواهي عن الازدهار في العالم العربي
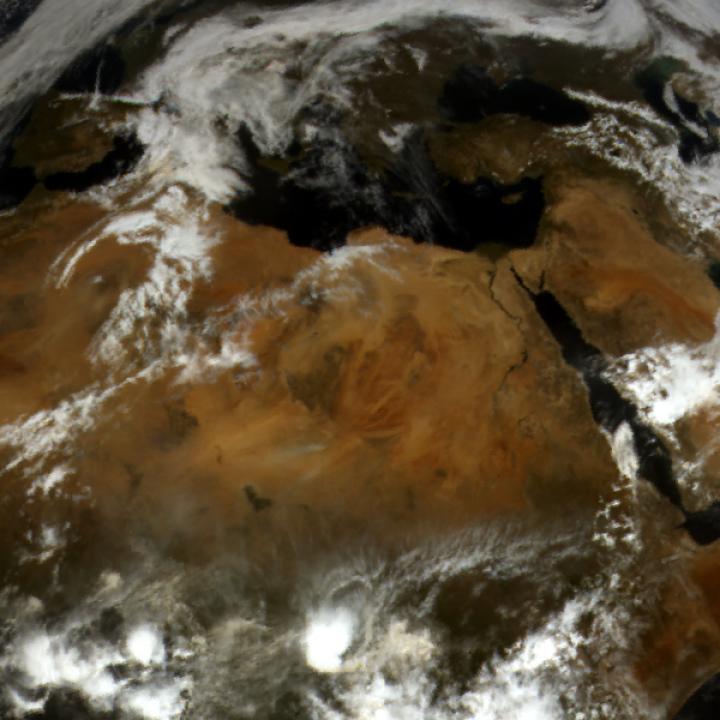
على الرغم من المحاولات الأخيرة لإنعاش العالم العربي، فإن الفشل في معالجة أزمة الاستقطاب بشكل فعال في المنطقة سيبقى عائقا رئيسيا أمام التنمية.
بعد مرور 10 سنوات على انطلاق ثورات "الربيع العربي"، تبدّد أي أثر للحماس والغبطة اللذين طبعا الأيام الأولى من الاحتجاجات التي عمّت الشوارع. وبدلًا من ذلك، طغت خيبة أمل واسعة النطاق وشعور واضح وملموس بالحنين في أرجاء العالم العربي لتلك الوحدة المفقودة التي انتشرت في خلال الأيام الأولى.
مثّلت الاحتجاجات الأولى في ميدان التحرير في مصر لحظة فريدة من الوحدة بين الحركات الشبابية والليبراليين والاشتراكيين والفصائل غير السياسية في المجتمع المصري. وشكّلت الصور المعبّرة للهلال المسلم يعانق الصليب المسيحي مع عبارات "نحن جميعًا ضد النظام" ومشهد المسيحيين الأقباط وهم يشكلون سلسلة بشرية لحماية المسلمين أثناء صلاة الجمعة، رمزًا لتلك اللحظة. وفي تونس أيضًا، أعطت "ثورة الياسمين" زخمًا للوحدة إذ وقفت الجهات الفاعلة في المجتمع المدني والقوى السياسية والمواطنون التونسيون العاديون يدًا بيد في وجه الفساد والظروف المعيشية السيئة وغياب الحرية.
غير أن التطورات اللاحقة تُظهر كيف أن هذه التحركات عجزت عن تفكيك الاستقطاب المتجذر والمعطّل الذي يشلّ الدول العربية – استقطاب أدّى إلى أزمة سياسية وطرق مسدودة وصراعات باردة ودموية إضافةً إلى حروب أهلية طويلة.
ويختلف الاستقطاب بطبيعته عن التباين في الآراء، إذ يُعتبر هذا الأخير مسألة صحية وطبيعية في المجتمعات وغالبًا ما يكون حجر الأساس لتحقيق الديمقراطية. أما الاستقطاب، فيحدث حين نرفض أن نعيش إلى جانب جار لا يشاطرنا الرأي والمعتقد أو ببساطة لا ينتمي إلى جماعتنا – المُعرّفة دينيًا أو اجتماعيًا أو سياسيًا أو عرقيًا أو اقتصاديًا أو حتى جيليًا. وما يمكّن عملية الاستقطاب هي الغريزة القبلية البدائية وسط اصطفافنا ضمن مجموعات متناحرة في لعبة لا غالب فيها ولا مغلوب. وفي إطار ترتيبات مماثلة، تصبح المفاوضات والتوافق والتسوية مستحيلة، حتى أنها تُعتبر خيانة.
ثمة مثل عربي قديم يقول: أنا ضد أخي. وأنا وأخي ضد ابن عمي. وأنا وأخي وابن عمي ضد الغريب. في حين يشير هذا المثل إلى القدرة على التوحّد ضد عدو أو تهديد متوقّع، إلا أنه يحمل في طياته استقطابًا ظرفيًا وثقافيًا واجتماعيًا ودينيًا راسخًا لا يمكن إخفاؤه، وهو استقطاب يهدّد بروز وتطوّر عقود اجتماعية عملياتية أساسية في معظم دول العالم العربي.
وفي حين أن الاستقطاب القاتل لا يؤثر في هذه المنطقة فحسب ولا تقتصر جذوره تاريخيًا على العالم العربي دون غيره، إلا أن العجز عن التغلب عليه لصالح إجماع معلل وعقود اجتماعية يُبقي هذه المنطقة من بين أكثر أنحاء العالم تضررًا بالصراعات.
ولكن لا بدّ من الإشارة إلى أن حجم الاستقطاب وآثاره تختلف من دولة عربية إلى أخرى. وتستحق حالة ليبيا ولبنان والمغرب المقارنة من أجل فهم أشكال الاستقطاب المختلفة وأثره المضر بالتنمية الاقتصادية والانتقال الديمقراطي.
فليبيا تُعتبر من بين الدول الأكثر تشرذمًا اجتماعيًا واستقطابًا سياسيًا في العالم العربي. وكانت اليد الحديدية لنظام القذافي قد سعت إلى إقامة نوع من الوحدة الشعبية القسرية في إطار مفهوم "الجماهيرية". وإذ تُعرّف الجماهيرية رسميًا على أنها تمثيل مباشر للشعب منظَّم من خلال مجالس شعبية، إلا أنها عمليًا كانت نظامًا استبداديًا وتعسفيًا. كما حاول نظام القذافي عبثًا الاستفادة من الإيديولوجيات العربية والأفريقية للدعوة إلى وحدة إقليمية. والآن، وبعد 10 سنوات على سقوط النظام، لا تزال ليبيا منقسمة ومتشرذمة تعاني لإنهاء العنف وبناء مؤسسات الدولة، إذ تقوم الجهات الفاعلة الخارجية بتأجيج الصراعات العشائرية والقبلية من خلال تزويد الأطراف المتصارعة بالمال والأسلحة، ولا يزال اتفاق السلام الموقع في الآونة الأخيرة في البلاد هشًا للغاية. وكما جاء في "الرسائل الرئيسية" خلال حفل تنصيب الحكومة الجديدة في 15 آذار/مارس، فإن المصالحة ولمّ الشمل وحماية حقوق الإنسان والقدرة على تلبية حاجات الشعب الأساسية هي من الشروط المهمة والرئيسية للسلام الدائم في ليبيا.
ويُعتبر لبنان مثالًا آخر في هذا الصدد؛ فالجمود السياسي الذي تشهده البلاد في الآونة الأخيرة ليس الأول وحتمًا لن يكون الأخير في سلسلة طويلة من الانقسامات السياسية والاجتماعية. وفي ظل وجود 18 طائفة معترف بها رسميًا، فإن لبنان هو أكثر مجتمعات العالم العربي تعددًا من حيث الإثنيات والأديان. ونظرًا إلى هذا المستوى من التنوع المحلي، اختار الإطار الطائفي لتشارك السلطة وضمان الاستقرار وإلى حدّ ما التمثيل السياسي على مستوى الجماعات الطائفية. وفي حين ضمن هذا الترتيب إرساء استقرار نسبي، لم يحل دون تعطّل المؤسسات أو الفراغ السياسي أو التوترات الطائفية. وبالفعل، يبدو أن إطار الترتيب الطائفي ساهم في ترسيخ الهويات الطائفية وحصر السلطة بأوساط النخب التقليدية وعزّز الزبائنية على أسس دينية ومذهبية. وفي نهاية المطاف، أدى الترتيب الذي صُمّم أساسًا لدعم التعايش والتعددية إلى تأجيج الاستقطاب وزيادة التكاليف المرتفعة المترتبة على مؤسسات الدولة غير الفعالة وهدر الطاقة والمياه والأزمات السياسية المتكررة، وهي عوامل تلحق الضرر بالتنمية الاقتصادية في البلاد.
وفي الطرف الجغرافي الآخر من العالم العربي، يشهد المغرب نوعًا دقيقًا من الاستقطاب. ففي المغرب، شهدت الاحتجاجات في الشارع التي ألهمتها ثورة "الربيع العربي"– والتي عُرفت باسم حركة 20 فبراير – على وقوف الفصائل السياسية المتعارضة عمومًا من اليسار المتطرف والإسلاميين يدًا بيد. ولم يطالب المحتجون مباشرة بتغيير النظام، بل ركزوا بدلًا من ذلك على شعارات تنادي بوضع حدّ للفساد إلى جانب المساءلة والحكم الرشيد. في الواقع، تعتبر العائلة المالكة في المغرب على أنها رمز للوحدة وقد حكمت البلاد لأربعة قرون متتالية. إن النظام السياسي في المغرب هو مزيج من المكونات الحديثة والتقليدية الممتدة في هياكل الدولة. ويتمحور هذا النظام السياسي القائم منذ ما قبل الاستعمار حول العائلة المالكة ومحيطها، مع تفويض بعض أشكال الإدارة المحلية إلى البيروقراطية التقليدية، وغالبًا ما يشار إليه بـ"المخزن". وفي الفترة الراهنة، أثبت "المخزن" قدرته على إعادة تشكيل صلاحياته التقليدية والموروثة والرمزية عن طريق المؤسسات السياسية الحديثة في المغرب.
غير أن هيكلية الحكم الهجينة هذه تساهم أيضًا في التوترات والاستقطاب، وبخاصةٍ حين تتعلق بالمصادقة على إصلاحات اجتماعية وحريات مدنية. وعليه، يُعتبر المجتمع المغربي اليوم مستقطبًا إلى حدّ كبير على صعيد مسائل كإصلاح قوانين الإرث وعدم تجريم العلاقات الرضائية والزواج من غير المغربي، ما يجعل من المستحيل حتى إجراء مناقشات هادئة تتناول هذه المسائل. ويسفر هذا الاستقطاب عن استمرار القوانين القديمة رسميًا بما يتعارض بالكامل مع حياة الكثيرة من المغربيين.
وتبيّن هذه الأمثلة الثلاثة الطبيعة المتغيرة وإنما الواسعة الانتشار للاستقطاب وآثاره الضارة في العالم العربي. غير أن انتشار وسائل الإعلام التقليدية ووسائل التواصل الاجتماعي في أرجاء العالم العربي شكّل في بعض الحالات قوات استقطاب إقليمية.
وفي جو عام حيث حرية التعبير محدودة، برزت "الجزيرة" على الساحة الإعلامية منذ تسعينيات القرن الماضي ومثّلت تغيرًا نموذجيًا في وجه وسائل إعلام عربية ضيقة الأفق شكليًا. وأشار شعار القناة "الرأي والرأي الآخر" إلى التزام بتغطية وجهات نظر متعددة. لكن هذه الموضوعية المعلنة دُحضت إلى حدّ كبير في خلال ثورة "الربيع العربي"؛ فقد استقال عدد من المراسلين والمذيعين واتهموا القناة بالافتقار إلى الموضوعية في تغطيتها للاحتجاجات وبأن هدفها الكامن يتمثل بالترويج لأجندة خاصة مع انحياز واضح لقطر. واليوم، يبدو واضحًا أن للقناة أجندتها السياسية الخاصة وغالبًا ما تدعم الجو المستقطب أساسًا.
إلا أن الخطر الحقيقي والقاتل للاستقطاب يتجلى بشكل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي، حتى أن بعض المنصات صارت ساحة أساسية للتطرف وتجنيد الجماعات الإرهابية. ولعبت وسائل التواصل الاجتماعي دورًا مهمًا في حشد الناشطين الشباب في خلال الأيام الأولى من "الربيع العربي"، إلى درجة أن البعض يشير إلى التحرك على أنه ثورة "فيسبوك" أو "تويتر". غير أن وسائل التواصل الاجتماعي قامت مقام أبواق ثورة "الربيع العربي" وليس آلية سببية لها – وأبواق حيوية على نحو خاص نظرًا إلى غياب وسائل إعلام حرة ومنفتحة في معظم دول المنطقة.
لكن بقدر ما كانت آثار التكنولوجيات الجديدة إيجابية على حرية الخطاب في العالم العربي، لا يمكننا أن نغفل عن مساوئها. فغالبًا ما كانت النتيجة البديهية لتحقيق ديمقراطية الإعلام في المجال السيبراني تتمثل بإلغاء المعايير الموضوعية للحق والباطل لصالح الأحكام التعسفية والشتائم، ما فاقم بالفعل التوترات وعزّز الاستقطاب. وفي ظل الإقرار بمساهمة وسائل التواصل الاجتماعي في التحرير السياسي في العالم العربي، إلا أنه لا يمكن تجاهل مخاطر الاستقطاب المتطرف ويجب أخذها على محمل الجدّ.
وفي غياب أي إرادة فعلية لتخطي الاستقطاب ومدّ الجسور بين مختلف الفصائل والأحزاب، ستستمر الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية في الدول العربية في التدهور لتنحدر إلى مزيد من الصراعات العنيفة وعجز عن تحقيق ازدهار اقتصادي مستدام في المنطقة.
فمبدأ التوصل إلى التوافق والتسويات غير موجود في عملية الانتقال الديمقراطي والتطور في معظم دول العالم العربي. وإلى حين معالجة هذه المشكلة بشكل مباشر ونظرًا إلى طابعها الملح، يهدّد استمرار الاستقطاب القوي في المنطقة نجاح أي مقاربة اقتصادية بغض النظر عن مدى أهميتها.
وفي وقت تعيد فيه دول العالم دراسة نماذجها الاقتصادية في أعقاب جائحة فيروس "كورونا" (كوفيد-٢٠١٩)، تناقش الكثير منها شروط الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي. وبالفعل، برزت مقاربات متنافسة لمعالجة مشاكل التطور: فالمنتدى الاقتصادي العالمي يقترح على سبيل المثال توجًها جديدًا أسماه "إعادة الضبط الكبرى" يوفر مجالًا أكبر أمام الاستدامة باعتبارها السبيل لإعادة بناء المجتمعات بعد جائحة "كورونا". أما "البنك الدولي"، فيدعو من جهته إلى عقد اجتماعي جديد يتضمن مجالًا أكبر لشبكات السلامة والخدمات الموجهة نحو التكنولوجيا والمرافق العامة الحديثة. وفي حين أن المقاربات المقترحة كثيرة من دون شك، سيواصل الاستقطاب القوي، على الأقل في العالم العربي، وضع العراقيل أمام الموافقة على مقاربة محددة صعبًا، وتطبيقها على أرض الواقع أكثر تعقيدًا. وإلى حين معالجة هذه المشاكل بشكل مباشر من قبل من هم في السلطة، وطالما أن أحزابًا متناحرة لا تزال ترفض التسوية، سيبقى تحقيق مستقبل أفضل لهذه الدول هدفًا صعب المنال.


